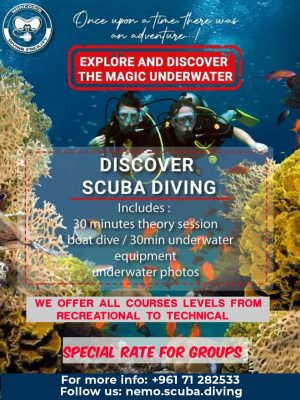ندوة رواية “سلطان وبغايا” للكاتبة هدى عيد
في اطار فعاليات اليوم الثاني، نظمت دار الفارابي ندوة حول رواية “سلطان وبغايا” للكاتبة هدى عيد شارك فيها الدكتور ناتالي خوري، الدكتورة نازك بدير وأدارها الاعلامي الشاعر اسكندر حبش في حضور حشد من المثقفين والمهتمين.
حبش
واستهل حبش الندوة بالقول أن: “سلطان وبغايا”، رواية ترتبط بأمكنة عديدة، وبأزمنة متعددة، لكنها في الواقع ترتبط بزمن واحد وبمكان واحد هما هذه الحياة التي تنبش في خفاياها لتقدم لنا من خلالها سيرة “سلطان”، وسيرة انزياحاته والشرور التي قام بها خلال مشوار العيش، مثلما تقدم – وبشكل موارب – (إن جاز التعبير) سيرة رغبته في التوبة والندم عن كل هذه الحيوات التي عرفها، من خلال النسيان وترك الماضي ليذهب بعيدا كي يندثر عبر الموت. لكن هل يندثر الماضي عبر الموت؟ لا أعتقد ربما لأن “الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا”. وهكذا بعد موت سلطان ثمة انتباه لكل ما جرى معه. إذ تقوم الرواية بأسرها على استذكار هذه الأحداث التي شكلت “امبراطورية الشر” التي نسج سلطان تفاصيلها وبطرق غير مشروعة، كي يبسط حضوره وقوته في مجتمع، لم يكن ليقبل ما فعله لو لم يكن هو – أي المجتمع – أكثر شرا منه.
وأضاف: بهذا المعنى، وإحدى القراءات الممكنة لرواية هدى عيد، لا تكمن في محاكمة سلطان عبر ما فعله، بل نجد أن الكاتبة تذهب – وبلعبتها الفنيّة الروائية – إلى محاكمة هذا المجتمع الذي سمح لشخصية مثل شخصية بطلها في التوسع وفي بسط نفوذه القوي، والمرعب. أي أننا – وبالعمق – نقف على المقلب الآخر من الديكور الذي تضعه أمامنا على خشبة المسرح، لكن “المسرحية” الحقيقية هي التي كان تدور في الكواليس.
واعتبر أنه من هذه الكواليس، تصعد الأصوات المتنوعة، المتداخلة، لتشكل كورسا يعيد ربط أجزاء الحكاية ببعضها البعض. كل شخصية من شخصيات هذا الكورس، تخبرنا عن ناحية معينة، وفي جمع النواحي، تتشكل السيرة، وتتشكل الحياة، ولتتشكل الرواية في نهاية الأمر.
وختم بالقول: مع روايتها السابعة، تحفر الكاتبة هدى عيد أكثر فأكثر في مشروعها الروائي، لتقدم لنا أكثر رواياتها اكتمالا أو لنقل أكثر رواياتها تجريبا إن من حيث المناخ أو من حيث الفضاء كما من حيث اللغة الروائية أيضا..
بدير
أشارت بدير بدورها الى أن صورة الشخصية الأساسية “سلطان” المقدَّمة في النّسق السّرديّ لم يتمّ الكشف عنها بشكل تقليديّ تراكميّ ، بل ارتبطت بالتفتيت، لأن ظهور جزئياتها ارتبط بمثير آنيّ (اللقاءات التي أجرتها زهية مع نساء سلطان ومعارفه والمقربين منه)، فكان على المتلقي أن يلمّ بهذه الجزئيات، ليصل في النهاية إلى صورة شبه كاملة عن البطل الغائب- الحاضر في كون القص….
خوري
أشارت خوري الى أن الرواية صرخة، كما تُحيلنا إليها صورة الغلاف، صرخة الكاتبة في وجه الشرّ المتقنّع بألف قناع…صرخةٌ من وجع تشيّؤ الإنسان، وتاليًا تسليعه، في وجه “من يتاجر بنفسه فترخص في عينيه نفوس الآخرين”، صرخة العقل على مفترق بين الوهم والحقيقة حين يعي استقالة الضمائر من مهامها…في سلطان وبغايا: العنوان وحده قنبلة تفجّر جدليّة علائقيّة بين الواحد الذي أُعطي السلطان المطلق في التحكّم بالمصائر، وبين البغايا، رمز المتعدّد السليب الكرامة.
عيد
وفي الختام تحدثت الروائية عيد قائلة: روايتي الجديدة (سلطان وبغايا) هي رواية الصراعات والتناقضات الإنسانية المتوترة، والمتولدة عن كثير من التحولات المجتمعية التي أصابت إنساننا المعاصر، أحاول من خلالها مسا” رفيقا” وأحيانا” موجعا” لجملة من الصراعات يخوضها الرجل اللبناني المعاصر كما تفعل المرأة، فأعرض لمسألة السلطة المواربة، والوصولية المهيمنة وللمظهري المنزاح عن جوهره وللدوس اليومي عل كل القيم التي صنعت إنساننا في يوم من الأيام ، ولأسلط الضوء كذلك على الجريمة التي لا تجد لها معاقبا” ولا رقيبا، والتي تترك الإنسان في مجتمعنا ذاهلا” من إفلات المجرم من العقاب، ومن توالي هذا الإفلات وصولا” إلى الاستباحة لأبسط الحقوق الإنسانية في زمن الحقوق والعقلنة والانفتاح!!!!
وأضافت: وهذا الابداعي الجمالي لن يصل ببيعده الانساني الى العام ما لم ينطلق من الخاص ويتحرى كل ما فيه، وأنا أؤمن بأن لنا حكايتنا الخاصة التي تستوجب من (فنيا خاصا) يقولها بلغتنا العربية الجميلة، وأنا أدرك أني وسواي من الروائيين والكتاب أمام قارىء مختلف، ذي مزاج مستجد، استلبه حركية العالم الحديث بتسارعها وبمشهديتها، وبنبض التحول المتراكض فيها، من هنا كان بحثي دائما عن أسلوب مختلف في المقال.
وختمت عيد بالقول: أعترف بأن هذه الاشكالية هي وحدة من هواجس الكتابة عندي، والتي حاولت من خلال هذه الرواية، ومن خلال رواياتي السابقة التنبه لها، ساعية الى اشراك القارىء في ما تقوله الرواية مع استمتاعه بالفني فيها، عامله وباخلاص عبر سطورها على نقل حالات القلق الانساني لديه، والاصغاء لارهاصات النفس البشرية حين تنتشي وتفرح، وحين تألم وتحزن، وحين تبدع وهي تقول، ساعية الى خلق عالم تخييلي يحيل على الواقعي المرجعي الشائه، لعلنا نعيد استقراءه، عوضا عن الهرب من هذا الواقعي المأزوم والاكتفاء بمجرد التقيؤ بظلال الأدب الوارفة، لئلا يكون فيؤها مجرد طيف يعبر الى حين.
محاضرة “أولادنا يعشقون التعبير الكتابي… ولكن كيف؟”
وفي اطار نشاطات دار البنان لهذا العام، نظمت محاضرة “أولادنا يعشقون التعبير الكتابي… ولكن كيف؟” ألقاها الباحث التّربويّ الدّكتور سلطان ناصر الدّين وقدم له الأستاذ أحمد وهبي في حضور حشد من التربويين والمهتمين والمثقفين.
وهبي
استهل وهبي تقديمه بالقول: والكلمةُ كانتْ منذُ البدءِ فعلاً طيّبًا أفاضَ اللهُ به على الإنسانِ بعدَ أنْ سوّاه ونفخَ فيه من روحِه. هي الكلمةُ الّتي أجراها على لسانِه فجعلَه بها المتميّزَ عن مخلوقاتِه، العاقلَ القادرَ على خوضِ غِمارِ المعارفِ والبحثِ عنها وفيها، ليكتشفَ بها كُنْهَ الوجودِ، ويفهمَ حقيقةَ الحياةِ وهدفيّتَها…والكلمةُ واللّسانُ منذُ كانا، سعى كلٌّ منهما إلى اللّقاءِ بِصِنْوِهِ، فالواحدُ منهما خُلِقَ لأجلِ الآخرِ في تكامُلٍ طبيعيٍّ وفطريٍّ، بعيدًا عن الاصطناعِ أو عواملِ التّأليفِ بينهما… ولذا كانَ الطّفلُ إذا أبصرَ النّورَ حرّكَ لسانَهُ بأصواتٍ يعبّرُ بها عن وجودِهِ، عن حاجاتِهِ، من قبلِ أنْ يَلِجَ بابَ كُتّابٍ أو مدرسةٍ.
وفي هذه الأمسيةِ الكريمةِ، تستضيفنا دارُ الـبَـنـانِ.. الدّارُ الّتي أنشأتْ بُنيانَها على مداميكِ العودةِ باللّغةِ العربيّةِ إلى بريقٍ قديمٍ، أخفاه غبارُ الأساليبِ القديمةِ المتحجّرةِ، فأعطَتِ الأقلامَ الشابّةَ فرصةَ الكتابةِ، مؤمنةً بأنّ اللّغةَ لا يجوز لها أن تقفَ عندَ زمنٍ مضى، لأنّها إنْ فعلَتْ كانَ مآلُها إلى الهلاكِ. ولأنّ الدّارَ آمنتْ بالتّجديدِ والتّحديثِ فقد حقّـقـتْ في فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ نجاحًا لافتًا؛ إذ أثرتِ المكتبةَ العربيّةَ الأدبيّةَ بعناوينَ ومؤلَّفاتٍ، يظَهَرُ اليومَ أثرُها واضحًا على ألسنةِ طلاّبِ اللّغةِ، وفي ما تخطُّهُ أقلامُهم على الورقِ… تنبري الدّارُ في هذه الأمسيةِ لتقدّمَ مؤسّسَها الّذي حملتْ فكرَه ورؤيتَه للغةِ وتعليمِها، الباحثَ المجدّدَ والأديبَ المبتكرَ الدّكتور سلطان ناصرالدّين، الّذي لطالما أشار في سنوات خلتْ، من هذا المنبرِ ومن منابرَ أخرى، إلى أنّ الخللَ ليسَ في ذاتِ اللّغةِ العربيّةِ، وإنّما في طرقِ مقاربتِها وتعليمِها، ثمّ لم يكتفِ بالمُشافهةِ النّظريّةِ؛ بل حوّلَ ذلك إلى واقعٍ ملموسٍ بأكثرَ من طريقةٍ وأسلوبٍ… هو بينَنا اليومَ ليسألَ ويُجيبَ، ويبيّنَ أنّ أولادَنا يعشقونَ اللّغةَ: قراءتَها وكتابتَها، ولكنْ كيف؟
ناصر الدين
اعتبر ناصر الدين في بداية محاضرته أن أولادنا يعشقون التّعبير لأنهم يحبّون أن يعبّروا بحركاتهم، بعيونهم، برسمهم، بمواقفهم، بكلامهم شفويًّا وكتابيًّا؛ أولادنا يعشقون التّعبير الكتابيّ؛ ولكن ثمّة ما يمنع هذه الخاصّيّة من أن تظهر إجراءً مُفْرحًا، فيعيش أولادنا في هَمّ لا يريدونه، وفي غَمّ ليس في طبيعتهم.
وتطرق بالشرح الى مهارات التّواصل أربع: الاستماع، والتّكلّم، والقراءة، والكتابة. فمهارتا التّلقّي هما: الاستماع والقراءة، وهما مهارتان مُدْخل؛ ومهارتا التّكلّم والكتابة هما مهارتا الرّدّ، وهما مهارتان مُنْتَج. ولا قيمة للمُدخل إذا لم يُرافقه مُنْتَج. فعندما يعبّر المرء يحفظ التّوازن بين المهارات الأربع؛ وهذا ما يسبّب راحة وطمأنينة. والمناهج الحديثة، في كلّ أنحاء العالم، دعت إلى إكساب المتعلّم اللّغاتِ وغيرَها بيسر وطمأنينة من خلال التّوازن بين مهارات التّواصل الأربع: الاستماع، والتّكلّم، والقراءة، والكتابة
وأشار ناصرالدين الى أن الطّبّ الحديث توصل إلى أنّ الكتابة ولاسيّما كتابة اليوميّات تعتبر علاجًا مهمًّا للشّخص في رفع مستوى الجهاز المناعيّ لديه…. وفي دراسة أجرتها الجمعيّة الأميركيّة الطّـبّـيّة تقول إنّ الطّلاّب الّذين يقومون بالكتابة يوميًّا ولا سيّما في التّعبير عن مشاعرهم ترتفع درجاتهم في الدّراسة، ويكونون بصحّة أفضل.
لذا وبناء على ما تقدم، اعتبر ناصر الدين أنّ التّعبير راحة للدّماغ ومنشّط له ومنظّم وزكاة ونماء لثروة فكريّة وجسديّة وحفاظ عليها وإثبات لهويّة؛ لهذا كلّه، أولادنا يعشقون التّعبير الكتابيّ، ونحن نعشق التّعبير الكتابيّ؛ لكنّ الواقع المؤلم يحول دون تحقّق هذه الخاصّيّة.
واعتبر أن أولادنا يتأفّفون من التّعبير الكتابيّ جراء غياب مهارات التّواصل، النّظرة العاجيّة للتّعبير، المناهج الحديثة التي ألزمت المعلّمين والطّلاّب بعدد محدّد واضح لدروس القواعد، النّظرة القمعيّة في تقييم التّعبير، غياب عادة القراءة الموجّهة والحرّة، غياب التّدريبات الّتي توظّف القواعد والبلاغة في التّعبير، قلّة التّدريبات التي تنمي مهارة التعبير، غياب التّقنيّات المساعدة على الكتابة والعملَ.
وفي اقتراحه للحلول والمقترحات العمليّة، شدد ناصر الدين على ضرورة تنمية مهارات التّواصل، تحرير التّعبير من فكرته النمطية، ضرورة التّحديد الواضح للأنواع الكتابيّة ، اعتماد معايير تقييم واضحة وعادلة ومناسبة لكلّ نوع من الأنواع الكتابيّة، تعويد الطّالب على القراءة الحرّة منذ الصّغر، تنمية المهارات بالتدريب والتقنيات المناسبة لها.
وختم محاضرته بالقول: إنّ التّعبير الكتابيّ حاجة للإنسان وحقّ له؛ وواجبنا رعاية هذا الحقّ بكلّ ما أوتينا من علم وحبّ؛ إنّ القراءة تصنع إنسانًا عارِفًا، وإنّ الكتابة تؤازر القراءة لتصنع إنسانًا دقيقًا منتجًا… أولادنا يعشقون الكتاب ويعشقون التّعبير الكتابيّ… ألا أبعدنا عنهم ما يحول دون ذلك.
ندوة رواية :” هجرة الآلهة والمدائن المجنونة ” للدكتورة ناتالي الخوري غريب
وفي اطار نشاطاتها الثقافية في المعرض ال59، نظمت دار سائر المشرق ندوة حول رواية :” هجرة الآلهة والمدائن المجنونة ” للدكتورة ناتالي الخوري غريب، شارك فيها الدكتور محمد علي مقلد، الدكتور حبيب فياض، الدكتور طوني الحاج وأدارتها الدكتورة مهى الخوري نصار، في حضور حشد من المثقفين والمهتمين.
الخوري نصار
استهلت الخوري نصار ندوتها بالقول أن هذه الرواية تفتيش عن الايمان والاخلاق والقيم والقضايا الكبرى في موازاة مادية الحيا واللافت اتى ذلك في تنقيب عقلاني وسبر في أعماق الروح، ونفور من الشرح والسرد غير الموظفين، وجرأة في معالجة
معضلات الفكر بمنطق روائي وبقدرة لافتة على تذويب الفلسفات بسلاسة بعيدا من الجفاف.
مقّلد
واعتبر مقلد من جهته أن المعادلات الفلسفيّة واللمحات الشعريّة تربط مفاصل الحوار في كلّ القضايا، ففي سياق بحثها عن أسئلة وأجوبة عن الله والإيمان والإلحاد، رسمت الكاتبة منطقة لقاء بين عائد من الجبّة وعائد من الشيوعيّة لعلّهما يلتقيان. وقد جعلتهما يلتقيان في منطقة مرتبكة بين الإيمان والإلحاد، غير أنّ قيمة هذا اللقاء تكمن في حصوله في دفء العلاقات الإنسانيّة، لا مكر العلاقات السياسيّة، أي حين لم يعد إيمان رجل الدين مجرد طقوس، ولم تعد شيوعيّة الحزبي تعصّبًا أعمى
للفكرة، وحين بحث كلّ منهما عن مصالحة مع الذات اولا.
واستطرد بالقول: أمّا الإيمان والإلحاد فهما أبعد من تأويل آية في النص الديني أو تفسير مغلوط لعبارة من كتاب ماركس. والأبطال –الأفكار، هي الحبّ، الحياة، الموت، الفلسفة، الدين ، التصوف، الحضارة، التاريخ، كلّها ضحيّة التشويه والتحريف والتدمير، والمجرم واحد هو الحرب.
الحاج
بدوره أشار الحاج الى أن هذه الرواية رحلة ثلاثيّة الأبعاد، أولا أنها سفر في مناطق الحرب في سوريا والعراق ولبنان وإفريقيا، حيث الإيبولا أخطر من الحرب، ثانيا كونها ثلاث حكايات حبّ، الحبّ المطلق نحو الكمال الإلهي، حب سامح بطل الرواية
ورهف الفتاة التي ستعمل معه، وحب حبيب سعد الشيوعي اللبناني وبسمة زوجة جابر، أما البعد الثالث وهو قسمان، قيم وأفكار وحكم، عبر فلسفة جماليّة رائعة. ومعلومات عامّة تاريخيّة وجغرافيّة وحضاريّة.
فيّاض
واعتبر فياض أن رواية “هجرة الآلهة والمدائن المجنونة” لناتالي خوري تنطوي على أشكال شتى من الفلسفات المضافة المعبر عنها بلغة أدبية راقية. ثمة في الرواية معالجة معمقة لإشكالية الإيمان والمصير والتعددية الدينية على ضوء فلسفة الدين، الأخلاق، النفس، السياسة، اللغة، التصوف.. حيث تذهب الروائية، عن طريق الرمزية والسرد، إلى رسم حد فاصل بين المعنى واللامعنى، الثبوت والنفي، الوجود والعدم، الإرادة والقدر، الإيمان والكفر، الموت والحياة، الغائية والعبث… لقد كانت موفقة ناتالي خوري إلى حد بعيد في وضع القضايا الكبرى للفلسفة والدين في حيز جغرافي وإطار زمني، والحكاية عنهما بلغة أدبية تزاوج في آن بين التفكيك والتركيب من دون أن تصادر المطلوب أمام القارئ، بل هي تقحم الأخير في عالمها، فتجعل منه شريكا في كلمات الرواية ومدياتها المفتوحة على أكثر من أفق للتأويل ..
أحمد سعداوي في حوار مع خالد المعالي
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني من المعرض لهذا العام، نظمت دار الجمل نشاطا ثقافيا حواريا بين الروائي العراقي أحمد سعداوي الحائز على جائزة «البوكر» العالمية بنسختها العربية بطبعتها التاسعة 2014 (جائزة الرواية العربية 2014) مع مؤسس ومدير دار الجمل الشاعر العراقي خالد المعالي في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
اعتبر سعداوي في بداية حديثه الى أن الرواية هي عمل انتاجي ياخذ الكثير من الوقت ويحتاج في نفس الوقت الى طاقة شعرية كبيرة بالاضافة الى المعلومات والتفاصيل، فلكي تخرج بعمل فني متميز مهما اختلفت ماهيته يجب أن تتمتع بحس فني اجتماعي ونفسي، ففي ظل الفيضان السردي الذي نشهده في أيامنا هذه من خلال وسائل التواصل السريعة جعل بعض الروائيين يتجهون للكتابة بطريقة الاعلام السريع أو بالطريقة التي يستطيع الروائي ايصال فكرته بسرعة وسهولة.
وتطرق خلال الحوار الى رواياته خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها روايته الصادرة عام 2014 “فرانكشتاين في بغداد” التي تروي قصة أم تحكمت بمصير حياة أولادها وفرضت عليهم نظام رقابة مشددة من شدة خوفها عليهم، حيث يمكن القول أنها رواية عن الأم التي تجسد حالة العنف العراقي.
وكان للحاضرين في الحوار شهادات في الروائي سعداوي ومنها: “هو انسان بسيط وبريء وروايته “فرانكشتاين” التي كانت نتاجا تراثيا عراقيا أثرت في النفوس وأتشارك في الرأي مع كثيرين في أن الأثر الواقي له دور كبير في كتابة الرواية حتى ولو كانت تفاصيلها وهمية
اطلاق مسابقة القصة القصيرة العربية
في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية
وفي اطار نشاطات وكالة التعليم الفرنسي في الخارج AEFE – البعثة العلمانية الفرنسية MLF ضمن مشاركتها في فعاليات معرض بيروت العربي والدولي للكتاب، تم اطلاق مسابقة القصة القصيرة العربية في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج بحضور الملحق الثقافي الفرنسي دونيس لوش والكاتبة هدى بركات كضيفة شرف في الوكالة والبعثة، حيث ستلتقي خلال الاسبوع بالطلاب من مختلف المدارس في ورش كتابة ابداعية ومناقشات حول اللغة العربية.
أمسية شعرية ” خفيفاً كزيت يضيئ ” للشاعر بلال المصري
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني من المعرض59، نظمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر أمسية شعرية بعنوان ” خفيفاً كزيت يضيئ ” للشاعر بلال المصري، شارك فيها الشعراء عاليا المصري الشواف صالح زمانان وقدمها كامل صالح في حضور حشد من متذوقي الشعر والمثقفين والمهتمين.
ألقى الشعراء مقتطفات من أبياتهم الشعرية ورافقهم عزفا ماغي أبي اللمع.
محاضرة ” علوم الإيزوتيريك أهي مصدر أو مرجع أم هي تراث المعرفة الحق وأصالتها؟
وفي اطار محاضرات علوم الايزوتيريك، نظمت منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء- علوم الايزوتيريك محاضرة بعنوان “علوم الإيزوتيريك أهي مصدرأو مرجع أم هي تراث المعرفة الحق وأصالتها؟ ” ألقاها الدكتور جوزيف مجدلاني وحضرها حشد من المهتمين.
انطلق الدكتور جوزيف مجدلاني قائلًا أنَّ “المعرفة الحق وُجدت قبل أي شيء وكل شيء، فهي سبقت العلم إلى الوجود… ومنها (من المعرفة) اشتُقت الفلسفات أولًا، ثم الأديان، فالعلوم، وأخيرًا الفنون”. ومن ثم أوضح أنّ “العلم أخذ ما أدركه من الفلسفة، ثم صقله وصاغه في قالب عملي تهون ممارسته. لذا نرى أن العلم لا يطوِّر نفسه بل يطوِّر الوسائل التي بها يتعرَّف إلى المعرفة. فالمعرفة في مفهومها المطلق سرّ ولغز: سرّ من يملك كل شيء ويشكو الافتقار… ولغز مَن ملك كلّ شيء من دون قصد الإدخار”.
كما شدد الدكتور مجدلاني في الندوة على أنَّ “الإيزوتيريك معرفة ما قبلها أخرى، من أصالة المعرفة وتراثها، فهي لم تتغير ولم تتأثر بشيء مع مرّ الزمن… من الحقيقة التي تحاكي مدارك المرء وبواطنه فتجعله يتفاعل معها…” شارحًا أنَّ الفارق شاسع بين المصدر والمرجع. فالأوّل الجوهر والثاني العَرَض؛ الأوّل الأصل والثاني انعكاسه؛ الأوّل الحقيقة والثاني الواقع. أمّا مراجع الإيزوتيريك فهي مصادر الإيزوتيريك، والعكس صحيح.
ختم الدكتور مجدلاني محاضرته بالقول إنَّ “الحكمة لا أن تقدِّم المعرفة إلى السائل، بل أن تعرِّفه إلى الطريق التي توصل إلى المعرفة. علمًا أنّ الحقائق الكبرى يصعب إدراكها إن لم تتوصل إليها بنفسك. والأهم أنّ كل جديد يصدم المنغلق ذهنيًا، في حين ينتشي به المتفتّح ذهنيًا…”.
وأنهى الدكتور مجدلاني محاضرته مذكراً أنه بالامكان الاطلاع على التفاصيل الوافية عن الإيزوتيريك من خلال مؤلفاته التي بلغت التسعين كتاباً حتى تاريخه بسبع لغات (منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت- لبنان) والمعروضة في الجناح الخاص بالإيزوتيريك (رقم B47)، وأيضًا من خلال المحاضرات المجانية الأسبوعية في مركز الإيزوتيريك الرسمي في الحازمية والموقع الرسمي على الانترنت www.esoteric-lebanon.com، أو من خلال الدخول الى منتدى الإيزوتيريك على الـ facebook والـ Twitter أو blog الإيزوتيريك (www.blog.esoteric-lebanon.org).
أعقب المحاضرة حوار أجاب فيه الدكتور مجدلاني عن أسئلة الحضور.
ندوة حول كتاب “الفسبكات – الدفتر الثاني” للدكتور أحمد بيضون
وفي اطار النشاطات الثقافية، نظمت دار النهضة ندوة حول كتاب “الفسبكات – الدفتر الثاني” للدكتور أحمد بيضون، شارك فيها الدكتور أحمد بيضون، الدكتور جورج دورليان، الأستاذ حازم صاغية وأدارها الأستاذ يوسف بزي في حضور حشد من المثقفين والمهتمين.
دورليان
وتمحورت كلمة دورليان حول الســــخرية في “فسبكات” أحمد بيضون، مشيرا الى أنه كتابٌ لم يعتنِ صاحبه بترتيب أبوابه، بل اكتفى باختيار – لا أدري إذا اختار فعلاً – بعض ما كتبه وأنزله حسب الترتيب الزمني من دون تدخّل من جانبه، تاركًا للقارئ عناء استخراج المضامين والثيمات التي تخترق الدردشة الفسبوكية. سأختار ما لذّ ليّ قراءته من قفشات سلّطت الضوء على شؤون ذات علاقة ببعض السلوكيات الاجتماعية من دينية وطائفية وغيرها…من بين هذه القفشات، اخترت تلك التي تتمتّع بالسخرية والاستهزاء بأمور ورموز يعتبرها بعض الناس اليوم مقدّسة وخطيرة.
واعتبر أنه كتاب الحكم Aphorismes ففيه مجموعة من الحكم تتطرّق إلى سلوكيات الناس وإلى قضايا لغوية وسياسية وحتى دينية. فالحنق في التخاطب، والكذب والعنف والظلم والحقيقة والبحث عنها، كلها أمورٌ يتجلّى الموقف منها في أسلوب حكمي مقتضب وسديد الإصابة، تهكّمي المنحى يغلب عليه منطق التضاد إبرازًا للمفارقة بين القول والفعل، بين الحقيقة والكذب.
أما على الصعيد اللغوي، بين بَطّيخٍ “يُفتح” وبِطّيخٍ “يُكسر” قبل أكله، وسكّين يسعها ادّعاء “الذكورة والأنوثة، فتدخل على الذكر والأنثى دون حاجة إلى محرم”، و”جماع” هو مزيج من “الدعس” و”المعس” الحنونين…..وذكورة تختصر في “خصيتين أنثيين…. يعطينا أحمد بيضون دروسًا في فقه اللغة ودلالاتها، فيذكّرنا بقواعد استعمال “إن” بعد فعل القول، و”باء” الجرّ الذي لا يدخل إلاّ على المتروك بعد فعل الاستبدال….
وأضاف دورليان: في الشؤون السياسية، يطال الاستهزاء والسخرية دولاً وقيادات وشعارات رائجة. فيدعو للتخفيف من عذابات شعوب المنطقة، إلى أن يتبارز بالمسدّس خادم الحرمين الشريفين والولي الفقيه/المرشد الأعلى بدل تصارع الطوائف والمذاهب، مللها ونحلها، “في طول هذا الشرق وعرضه”… أما في الإطار اللبناني فهو يستحضر بيضون شعار غسّان تويني “حروب الآخرين على أرضنا” مصحّحًا إياه ليصبح “شعوب الآخرين على أرضنا” محاكاة لشعار ميشال شيحا “لبنان الأقليات المتشاركة”. أما تمسّك خصوم السلفيين بما يسمّيه “نقطة النفاق” الديمقراطي، فيرى أنه يجهر عكس ما يضمر: “يقولون دولة، ويضمرون طائفة، وعائلة وعصابة. وعليه يكلّفون الناس مشقّة الانتخاب، ويكلّفون أنفسهم مشقّة تزويره”. في الموضوع الوطني، يتساءل “هل من مقاومة” لاسترداد أراضٍ استولى عليها نصّابون من لبنان؟ وهي أراضٍ مساحتها أكبر من المساحة الفعلية لمزارع شبعا. والسؤال موجّه لمن ليس بحاجة لنسمّيه.
وأضاف: وأخيرًا … نصل إلى السخرية الأخطر، تلك المتعلّقة بأمور الدين. فكلامه لا يستثني أحدًا ولا موضوعًا يتّصل بالشأن الديني. .. في اقترابه من الموضوع الديني، يتجاوز أحمد بيضون المحظورات والممنوعات مع تمسّكه باللياقة أسلوبًا ومعالجةً. فكل شيء بالنسبة إليه مسموح، والكل يعبر بسلاسة في مدوّنته أو، كما يقول، في “عرضحاله”: الكائنات الدينية من الله ومرسليه، إلى المقامات الدينية من بطاركة ومفتين ومشايخ وفقهاء ومفكّرين، ومؤسسات دينية من طوائف ومذاهب… تحضر في مدوّنته أيضًا المفاهيم الدينية وصورها في الدنيا والآخرة… كلها أمورٌ يقترب منها بأسلوب يزاوج بين التهكّم والرصانة، وينطلق من كيفية ممارسة الدين من قبل من يدّعون أنهم مؤمنون.
وختم بالقول: أكتفي بهذه الأمثلة لا خشية من الرقابة أو من رجال الدين، بل لأترك للقارئ لذّة اكتشاف ما يتضمّنه هذا الكتاب من إشراقات ساطعة تضيء القبيح في قبحه، وترسم طريقًا للتفكّر السليم يوصلنا إلى حيث تنبسط مساحة الفكر النقدي الذي يعالج الظواهر الإنسانية من دون تقبّلها ببلاهة المتزمّت الجاهل.
صاغية
استهل صاغية كلمته بالقول: منذ أن غادر الفيسبوك أسوار جامعة هارفرد، والكتابات والتحليلات، الأميركيّة والأوروبيّة، تتناوله بالنقد والمراجعة. فهناك من يأخذ عليه كونه أداة انتهاك لخصوصيّة الأفراد، ومن يباركه لأنّه يمنح الفرد تعبيراً عن فرديّته لم يكن متاحاً من قبل. … وفي غابة كهذه من اختلاط المعاني والدلالات، يضاف أمر آخر يسري علينا كما يسري على غيرنا: كيف يُكتب في الفيسبوك؟ كيف تُميَّز الكتابة الفيسبوكيّة عن كلامنا الشفويّ المعهود وكيف تُميَّز، في المقابل، عن كتابة الكتاب أو الكتابة للصحيفة؟ وتالياً، من هو الجمهور المتلقّي الذي يغاير جمهور الجريدة أو الكتاب غيرَ المشروط بوجوه وملامح وأسماء؟، وأين يستقلّ، مثلاً لا حصراً، التلييك والتشيير بذاتهما عن العلاقات الشخصيّة والقناعات السياسيّة بما يرفعهما قليلاً أو كثيراً في سلّم الموضوعيّة؟
واستطرد قائلا: يُخيّل إليّ أنّ أحمد بيضون الذي لامس بعض هذه الأسئلة وسواها في دفتره الأوّل، ترك هذه الآلة الجديدة تفكّر وظيفتها مختاراً أن يجيب بطريقة خاصّة جدّاً. وطريقته هذه مفادها منح الأولويّة للكتابة والكتابيّة بعد تركيزهما على ما أسماه “فنّ الخاطرة”. فأحمد كمثل عاشق عشيقته الكتابة، والحبيب لا يهمّه المكان الذي يلتقي فيه الحبيبة، ولا تعريف ذاك المكان وتفاصيله، بقدر ما يهمّه أن يلتقيها فيه، فكأنّه يطبّق قولة دينغ هسياو بنغ الشهيرة “ليس المهمّ لون القطّة، بل المهمّ أن تصطاد الفئران”. ففي هذه الغرفة تُمارَس كتابة البحث، وفي تلك كتابة المقالة، أمّا في غرفة الفيسبوك تحديداً، فتُكتب الخاطرة التي قد يعنّ لها مرّاتٍ أن تتاخم المقالة أو تجاور البحث، كما يمكنها مرّاتٍ أخرى أن تسخر وتَضحك وتُضحك.
واعتبر صاغية أن المهم هو الكتابة التي يتولّى أحمد حراسة مرماها، وهو لهذا لا يكتب في الفيسبوك إلاّ ما يُكتب، علماً بأنّ السائد في استخدامه هو كتابة ما لا يُكتب. وفي المعنى هذا نراه يطوّع الفيسبوك للكتابة، مانحاً إيّاها ميداناً جديداً، بدل تطويعه الكتابة للفيسبوك. ولا نستطيع مطالبة العاشق بأن يعشق اثنتين بالقدر نفسه، إذ أنّ ولاء كهذا للكتابة لا بدّ أن يرافقه شيء من الخيانة، أو في الحدّ الأدنى التوظيف، لما ليس كتابةً محضة.
وأكمل قائلا: برهاننا الذي لا يُدحض على ذلك أنّ أحمد استطاع أن ينتج كتابين، أو دفترين، ممّا أسماه فسبكة. فالشيء بمجرّد أن يُكتب، في الفيسبوك أو في سواه، يغدو صالحاً لأن يُنشر بأحرف محرّكة وشدّاتٍ مُصانة. وهذا تعالٍ وتفارُق يُعزيان إلى عمل الكتابة، يعزّز طبيعته هذه شخص أحمد الذي لا يعرف الإسفاف. وبهذا المزيج الذي يضمّه والكتابة يتبدّى فايسبوكه خالياً من الإسفاف خلوّه من الصغائر. لكنّه يتبدّى أيضاً متصلّباً في رفض المجاملة بالتلييك، على غرار لايك بلايك، إذ هي لا تندرج في قيم المزيج بمكوّنيه، كما يتبدّى متصلّباً في الامتناع عن كتابة “ههههه” تنبيهاً إلى أنّه يمزح، معوّلاً فحسب على قوّة الكتابة المازحة.
وقبل كلّ حساب وبعده، فإنّ الكمّ والنوع اللذين كتبهما عن الثقافة واللغة يشجّعان على اتّهامه بالأصوليّة، في ما خصّ الكتابيّة وما تتوسّله من لغة، ويشغلان بالنا على أحمد حين يُضطرّ إلى “تدنيس” الكتابة بالردّ كتابيّاً على فاتورة كهرباء مبالغة أو فاتورة بائع خضار طمّاع.
وقال صاغية: أمّا في ما عدا الكتابة، أو ما كان دونها، فهو مثل صاحبه دينغ هسياو بنغ، قليل الدوغمائيّة، كثير البراغماتيّة، لا يكتفي بقبول التعدّد في كلام الغرف وبتطبيق مبدأ “لكلّ مقام مقال”، بل يتيمّن بالمحارب أحياناً فيطلب استراحةً عابرة، هي، في الغالب، نشر صورة من أرشيفه. وتحديدٌ كهذا لعمل الفيسبوك له، في ما أظنّ، أسبابه في تكوين أحمد بيضون الشخصيّ. فهو في مقدّمة كتابه المرجعيّ عن رياض الصلح ذكر أنّه يتعلّم من المناهج جميعاً من دون أن يُلزم نفسه بواحد منها. كذلك كتب في مناسبة فيسبوكيّة حديثة العهد أنّه يكره الرائج والموضة.
وخلص للقول: وقد تفيدنا هاتان الملاحظتان في تفسير الاستخدام البيضونيّ للفايسبوك ولتوظيفه، من ثمّ، غرفةً من غرف كثيرة لخدمة غرض هو أبقى من الموضة وأعرض من الامتثال لمنهج.
فالحُرّ الذي يقارب الفوضويّ في أحمد يجعله عاصياً على الانضباط في ما ناقشه واختلف حوله حكماء الفيسبوك وكهنته. وهذه الحرّيّة سخيّة ككلّ الحرّيّات، أعطتنا، هذه المرّة، كتاباً جميلاً آخر.
فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال59 في يومه الثاني الأحد (29/11/2015) – تجدون ربطا الصور
| علي عبد المجيد عباس | ” خريف دمشق “ | دار الفارابي |
| إبراهيم عيسى | ” لي موعد مع القدر “ | دار الفارابي |
| هدى عيد | ” سلطان وبغايا “ | دار الفارابي |
| ديانا بربير | كي كي في ورطة | دار أصالة |
| د. ماريا كريستي باخوس | كتاب طلال درجاني ” جدلية ستانيسلافيسكي ومايرخولد 1/2 | دار الفاربي |
| لبنى نويهض، ندى معوض، بول أبي درغام | بصمات من القارة المندثرة و في محراب القلب والهوية الضائعة | الإيزوتيريك |
| فاطمة شرف الدين و لوركا سبيتي | سمسم في بطن ماما | دار الساقي |
| د. جمال زعيتر | دراسة في لوحة الفنان شوقي دلال | النادي الثقافي العربي |
| د. صالح زهر الدين | من جبل موسى الى حوش موسى عنجر | النادي الثقافي العربي |
| د. توفيق بحمد | أمين والنبي | النادي الثقافي العربي |
| د. شوقي أبو لطيف | الاسلام والعولمة | النادي الثقافي العربي |
| أ. سليمان يوسف ابراهيم | “راحات المسك” و “نضال الحبر” | النادي الثقافي العربي |
| أ. شادي سرايا | فلسفة الروح | النادي الثقافي العربي |
| الشاعر سعيد أبو الزور | ديوان ” ملح الحكي “ | النادي الثقافي العربي |
| الشاعرة ليلى زيدان صالحة | ديوان ” عشتار تخاطب الألهة “ | النادي الثقافي العربي |
| الشاعرة ياسمين حسن بتديني | ديوان ” رذاذ الياسمين “ | النادي الثقافي العربي |
| د. عمر نشابة | ذاك المكان | دار كتب |
| بيار مالك | الفلسفة وتعليمها | دار النهضة العربية |
| سناء شباني | مغامرة في الشارع | دار الفكر اللبناني |
| عطالله دعيبس | دمعة قلم | دار الرحاب الحديثة |
| سمر قطان | المسرح العلاجي | دار النهضة العربية |
| لينا هويان الحسن | البحث عن الصقر غنّام | دار الآداب |
| سندس برهوم | عتبة الباب | مكتبة إنطوان |
| ريم رفعت النمر | إمرأة من فلسطين | دار الريس |
| أنيس النقاش | الكونفدرالية المشرقية | دار بيسان |
| ياسمين حناوي | فلامنكو | دار العربية للعلوم ناشرون |
| د. ناتالي الخوري غريب | ” هجرة الآلهة والمدائن المجنونة “ | دار سائر المشرق |
| سامي يحيي | ” الأرزة اللبنانية “ | encyclomedia |
| هالة مراد | ” ربيع الإنتظار “ | دار الفارابي |
| جنان حشاش | الشاطر حسن والمارد | دار أصالة |
| معين الطاهر | حوار مع معين الطاهر و شخصيات جدلية في الفكر العربي | منشورات ضفاف |
| نافذ أبو حسنة | عسل المرايا | منشورات ضفاف |
| زينة قاسم | عبور | دار العلم للملايين |
| رندلى منصور | حرية وراء القضبان | دار العربية للعلوم ناشرون |
| د. مروان أبو لطيف | ” أرخبيل العشائر ” و ” كتاب لكن “ | دار الفارابي |
فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الاثنين الموافق فيه 30 تشرين الثاني 2015
| 4:30 – 6:00 | ندوة حول كتاب “تجربة التمثيل الشعبي في المقاطعات اللبنانية 1861-1915” | د. محمد مراد | الدار العربية للعلوم والنشر |
| التحديات الالكترونية | مهدي | ||
| 6:00 – 7:30 | لقاء تكريمي للفنان رفيق علي أحمد | أ. رولا حمادة – أ. عبده وازن – أ. غدي الرحباني – ادارة زاهي وهبي | النادي الثقافي العربي |
| 6:00 – 7:30 | ندوة حول كتاب “تصدعات مركز الحضارة الانسانية عبر الأزمنة” للأستاذ نبيه الأعور | د. مسعود ضاهر – د. رياض غنام – تقديم أ. كمال ذبيان | دار التراث الأدبي |
نشاطات Beirut Digital Space:
- 5:00 – Souk Designer من GraphicShop
- 6:00: مايا سيوفي – Tech Review Pan Arab
التواقيع
| 4:00-6:00 | رواية ” تهافت الأيام الآتية “ | يوسف إليان | دار الفارابي |
| 4:00-7:00 | ” ماريكا المجدلية “ | إيلي صليبا | دار سائر المشرق |
| 5:00-8:00 | وداعاً يا زكرين | رشاد أبو شاور | دار الآداب |
| 5:00-7:00 | غريقة بحيرة موريه | إتطوان الدويهي | دار العربية للعلوم ناشرون |
| 5:00-7:00 | كتاب الدماغ هذا المجهول | د. حسين منصور | منتدى المعارف |
| 5:00-8:00 | لماذا لا يثور العراقيون | د. صلاح شبر | دار المحجة البيضاء |
| 6:00-7:30 | ” على أراضي جمهوريتي “ | عطالله سليم | دار الفارابي |
| 6:00-8:00 | أكره كل النساء | باسكال عساف | النادي الثقافي العربي |
| 6:00-8:00 | قناديل العسكر؟ | فادي سهو | منشورات ضفاف |
| 6:00-8:00 | شعر الفداء والإنبعاث | د. لؤي زيتوني | دار نلسن |
| 6:00-8:00 | “Full Moon Gauro” | عوني عبد الرحيم | النادي الثقافي العربي |
| 6:30-8:00 | ” كيف تقود نفسك للنجاح في الدنيا والآخرة ” و ” حواء: تكوينها وخصائصها “ | شيرين خورشيد | النادي الثقافي العربي |
| 7:00-9:00 | تضحية برحم إمرأة | هند مطر | دار العربية للعلوم ناشرون |
| 8:00-10:00 | العطر والفقر وما بينهما | إسماعيل الأمين | شركة المطبوعات |